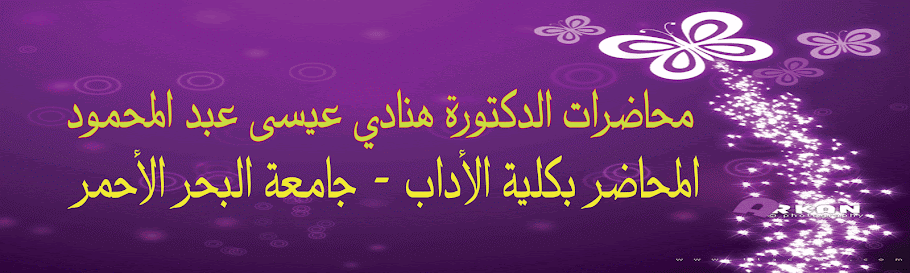بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة البحر الأحمر
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
قسم الدراسات الإسلامية
جامعة البحر الأحمر
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
قسم الدراسات الإسلامية
التوحيد و مباحث الإيمان
12
12
الشرك وأنواعه
●
الانحراف
في حياة البشرية:
●
خلق الله
الخلق لعبادته، وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الْمَتِينُ} [الذاريات: 56- 58] .
●
والنفسُ
بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية، مُحبَّةً لله، تعبدُه لا تُشرك به
شيئًا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يُزيِّنُ لها شياطين الإنس والجن بما
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا، فالتوحيد مركوز في الفطرة، والشرك طارئ
ودخيل عليها، قال الله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ
اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ}
[الروم: 30] .
●
وقال -
صلى الله عليه وسلم -: «كل مولود يُولَدُ على الفطرة فأبواه يُهوِّدانه، أو
يُنصِّرانه، أو يُمجِّسانه» . فالأصلُ في بني آدم: التوحيد.
●
والدينُ
الإسلام، وكان عليه آدم عليه السلام، ومن جاءَ بعدَهُ من ذُرّيته قُرونًا طويلة،
قال تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ} [البقرة: 213] .
●
وأوَّلُ
ما حدثَ الشركُ والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح، فكانَ عليه السلام أول
رسول إلى البشرية بعد حدوث الشرك فيها: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا
أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163] .
●
قال ابن
عباس: كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرةُ قرون؛ كلهم على الإسلام.
●
قال ابن
القيم (وهذا القولُ هو الصواب قطعًا؛ فإنَّ قراءة أُبيّ بنِ كعبٍ - يعني: في آية
البقرة -: (فاختلفوا فبعث الله النبيين) .قال تعالى في سورة يونس: {وَمَا كَانَ
النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا} [يونس: 19] .
●
يريد -
رَحمهُ الله - أنَّ بعثةَ النبيين سببُها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين
الصحيح، كما كانت العربُ بعد ذلك على دين إبراهيمَ عليه السلام؛ حتى جاء عمرو بن
لحي الخزاعي فغيّر دينَ إبراهيم، وجلبَ الأصنام إلى أرض العرب، وإلى أرض الحجاز
بصفة خاصة، فعُبدت من دون الله، وانتشر الشركُ في هذه البلاد المقدسة، وما جاورها؛
إلى أن بعثَ الله نبيه محمدًا خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - فدعا الناس إلى
التوحيد، واتّباع ملَّة إبراهيم، وجاهد في الله حق جهاده؛ حتى عادت عقيدة التوحيد
●
وسارت
على نهجه القرون المفضَّلَة من صدر هذه الأمة؛ إلى أن فشا الجهل في القرون
المتأخرة، ودخلها الدخيلُ من الديانات الأخرى، فعاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة؛
بسبب دعاة الضلالة، وبسبب البناء على القبور، متمثلًا بتعظيم الأولياء والصالحين،
وادعاء المحبة لهم؛ حتى بنيت الأضرحة على قبورهم، واتخذت أوثانًا تُعبدُ من دون
الله، بأنواع القُربات من دعاء واستغاثة، وذبح ونذر لمقامهم. وسَموا هذا الشرك:
توسُّلًا بالصالحين، وإظهارًا لمحبتهم، وليس عبادة لهم، بزعمهم، ونسوا أن هذا هو
قول المشركين الأولين حين يقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى
اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3] .
●
ومع هذا
الشرك الذي وقع في البشرية قديمًا وحديثًا، فالأكثرية منهم يؤمنون بتوحيد
الربوبية، وإنما يُشركون في العبادة، كما قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ
بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] .
●
ولم يجحد
وجودَ الرب إلا نزرٌ يسير من البشر، كفرعون والملاحدة الدهريين، والشيوعيين في هذا
الزمان، وجحودهم به من باب المكابرة، وإلا فهم مضطرون للإقرار به في باطنهم،
وقرارة نفوسهم، كما قال تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: 14] .
●
تعرف الشرك وأنواعه:
●
أ -
تعريفه: الشرك هو: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته.
●
والغالب
الإشراك في الألوهية؛ بأن يدعو مع الله غيره، أو يَصرفَ له شيئًا من أنواع
العبادة، كالذبح والنذر، والخوف والرجاء والمحبة. والشركُ أعظمُ الذنوب؛ وذلك
لأمور:
●
1 - لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فمن أشرك مع
الله أحدًا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم، قال تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ} [لقمان: 13] .
●
والظلم
هو: وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها،
وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم.
●
2 - أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، قال تعالى: {إِنَّ
اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ} [النساء: 48] .
●
3 - أن الله أخبر أنه حرَّم الجنة على المشرك، وأنه خالد مخلد في
نار جهنم، قال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}
[المائدة: 72] .
●
4 - أنَّ الشركَ يُحبطُ جميعَ الأعمال، قال تعالى: {وَلَوْ
أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88] .
●
وقال
تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر:
65] .
●
5 - أنَّ المشرك حلالُ الدم والمال، قال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
مَرْصَدٍ} [التوبة: 5] .
●
وقال
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرتُ أن أقاتلَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله،
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» .
●
6 - أنَّ الشركَ أكبرُ الكبائر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق
الوالدين ... » الحديث.
●
قال
العلامة ابن القيم: (أخبر سُبحانه أن القصد بالخلق والأمر: أن يُعرفَ بأسمائه
وصفاته، ويُعبدَ وحده لا يُشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به
السماوات والأرض، كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}
[الحديد: 25] .
●
من أعظم
القسط: التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه؛ وإن الشرك ظلم كما قال تعالى: {إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] .
●
فالشرك
أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل؛ فما كان أشد منافاةً لهذا المقصود فهو أكبر
الكبائر) .
●
7- أنَّ الشركَ تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما، فمن أشرك
بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادَّةِ لله تعالى، وغاية
المعاندة والمشاقَّة لله.
●
● أنواع الشرك الشرك
نوعان:
●
النوع
الأول: شرك أكبر يُخرج من الملة، ويخلَّدُ صاحبُهُ في النار، إذا مات ولم يتب منه،
وهو صرفُ شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله، والتقرب بالذبائح
والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو الجن أو
الشياطين أن يضروه أو يُمرضوه، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء
الحاجات، وتفريج الكُربات، مما يُمارسُ الآن حولَ الأضرحة المبنية على قبور الأولياء
والصالحين، قال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ
أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [يونس: 18] .
●
والنوع
الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة؛ لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك
الأكبر، وهو قسمان:
●
القسم
الأول: شرك ظاهر على اللسان والجوارح وهو: ألفاظ وأفعال، فالألفاظ كالحلف بغير
الله، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . وقول: ما
شاء الله وشئت، قال - صلى الله عليه وسلم -: لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت،
فقال: «أجعلتني لله نِدًّا؟ ! قُلْ: ما شاءَ الله وحده» . وقول: لولا الله وفلان،
والصوابُ أن يُقالَ: ما شاءَ الله ثُمَّ شاء فلان؛ ولولا الله ثمَّ فلان، لأن (ثم)
تفيدُ الترتيب مع التراخي، وتجعلُ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى:
{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير:
29] .
●
وأما
الواو: فهي لمطلق الجمع والاشتراك، لا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا؛ ومثلُه قول: ما
لي إلا الله وأنت، و: هذا من بركات الله وبركاتك.
●
وأما
الأفعال: فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، ومثل تعليق التمائم خوفًا
من العين وغيرها؛ إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه، فهذا شرك أصغر؛ لأن
الله لم يجعل هذه أسبابًا، أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك
أكبر لأنه تَعلَّق بغير الله.
●
القسم
الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات، كالرياء والسمعة،
كأن يعمل عملًا مما يتقرب به إلى الله؛ يريد به ثناء الناس عليه، كأن يُحسن صلاته،
أو يتصدق؛ لأجل أن يُمدح ويُثنى عليه، أو يتلفظ بالذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأجل
أن يسمعه الناس، فيُثنوا عليه ويمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطله، قال الله
تعالى:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] .
●
وقال
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أخوفُ ما أخافُ عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا
رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء» .
●
ومنه:
العملُ لأجل الطمع الدنيوي، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال، أو يتعلم
العلم الشرعي، أو يجاهد لأجل المال. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تَعِسَ
عبدُ الدينار، وتَعِسَ عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أُعطي
رضي، وإن لم يُعطَ سخط» .
●
قال
الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي
لا ساحل له، وقلَّ من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله، ونوى شيئًا غير
التقرب إليه وطلب الجزاء منه؛ فقد أشرك في نيته وإرادته، والإخلاص: أن يُخلصَ لله
في أفعاله وأقواله، وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله
بها عباده كلهم، ولا يُقبلُ من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، كما قال تعالى:
{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85] .
●
وهي
ملَّةُ إبراهيمَ - عليه السلام - التي من رغب عنها فهو من أسفَهِ السُّفهاء)
انتهى.
●
يتلخَّصُ
مما مرّ أن هناك فروقًا بين الشرك الأكبر والأصغر، وهي:
●
1- الشرك الأكبر: يُخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يُخرج من
الملة، لكنه ينقص التوحيد.
●
2- الشرك الأكبرُ يخلَّدُ صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا
يُخلَّد صاحبُه فيها إن دَخَلها.
●
3- الشركُ الأكبرُ يحبطُ جميعَ الأعمال، والشركُ الأصغرُ لا
يُحبِطُ جميع الأعمال، وإنما يُحبِطُ الرياءُ والعملُ لأجل الدنيا العملَ الذي
خالطاه فقط.
●
4- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما.
● الكفر: تعريفه –
أنواعه:
●
أ -
تعريفه:
●
الكفر في
اللغة: التغطية والستر، والكفر شرعًا: ضد الإيمان، فإنَّ الكُفرَ: عدم الإيمان
بالله ورسله، سواءً كان معه تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب، بل مجرد شك وريب أو إعراض
أو حسد، أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب
أعظم كفرًا، وكذلك الجاحدُ والمكذِّب حسدًا؛ مع استيقان صدق الرسل.
●
ب -
أنواعه:
●
الكفر
نوعان: النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملة، وهو خمسة أقسام:
●
القسم
الأول: كُفرُ التَّكذيب، والدَّليلُ: قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ
فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ} [العنكبوت: 68] .
●
القسم
الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 34] .
●
القسم
الثالث: كفرُ الشّكِّ، وهو كفر الظّنّ، والدليل قوله تعالى: {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ
وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا
أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا
مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ
بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا
لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا} [الكهف: 35- 38] .
●
القسم
الرابع: كفرُ الإعراضِ، والدليلُ قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا
أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: 3] .
●
القسم
الخامس: كفرُ النّفاقِ، والدليلُ قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ
كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} [المنافقين: 3] .
●
النوع
الثاني: كفرٌ أصغرُ لا يُخرجُ من الملة، وهو الكفرُ العملي، وهو الذنوب التي وردت
تسميتها في الكتاب والسنة كُفرًا، وهي لا تصلُ إلى حدِّ الكفر الأكبر، مثل كفر
النعمة المذكور في قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ} [النحل: 112] .
●
ومثلُ
قتال المسلم المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلمِ فُسوقٌ،
وقتالُه كفر» .
●
وفي قوله
- صلى الله عليه وسلم -: «لا تَرجعوا بعدي كُفَّارًا يضربُ بعضكم رقابَ بعض» .
●
ومثل
الحلف بغير الله، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»
.
●
فقد جعل
الله مُرتكِبَ الكبيرة مُؤمنًا، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] .
●
فلم
يُخرج القاتلَ من الذين آمنوا، وجعله أخًا لولي القصاص فقال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}
[البقرة: 178] .
●
والمرادُ:
أخوة الدين، بلا ريب.
●
وقال
تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] .
●
إلى
قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}
[الحجرات: 10] .
●
وملخص
الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر:
●
1- أنَّ الكفر الأكبر يُخرجُ من الملة، ويحبط الأعمال، والكُفر
الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال، لكن ينقصُها بحسبه، ويعرِّضُ صاحبَها
للوعيد.
●
2- أنَّ الكفرَ الأكبرَ يُخلد صاحبه في النار، والكفر الأصغر إذا
دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها؛ وقد يتوب الله على صاحبه، فلا يدخله النار
أصلًا.
●
3- أنَّ الكفرَ الأكبرَ يُبيح الدم والمال، والكفر الأصغر لا يُبيحُ
الدم والمال.
●
4- أن الكفر الأكبر يُوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين
المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب، وأما الكفر الأصغر
فإنهُ لا يمنع الموالاة مطلقًا، بل صاحبه يُحَبُّ ويُوالى بقدر ما فيه من الإيمان،
ويبغض ويُعادى بقدر ما فيه من العصيان.
● النفاق: تعريفه،
أنواعه:
●
أ -
تعريفه:
●
النفاق
لغة: مصدر نافق، يُقال: نافق يُنافق نفاقًا ومنافقة، وهو مأخوذ من النافقاء: أحد
مخارج اليربوع من جحره؛ فإنه إذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر، وخرج منه، وقيل: هو
من النفق وهو: السِّرُ الذي يستتر فيه.
●
وأما
النفاق في الشرع فمعناه: إظهارُ الإسلام والخير، وإبطانُ الكفر والشر؛ سمي بذلك
لأنه يدخل في الشرع من باب، ويخرج منه من باب آخر، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله:
{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة: 67] .
●
أي:
الخارجون من الشرع.
●
وجعل
الله المنافقين شرًّا من الكافرين فقال: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: 145] .
●
وقال
تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النساء:
142] ، {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ
مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [البقرة: 9، 10] .
●
ب -
أنواع النفاق:
●
النفاق
نوعان: النوع الأول: النفاقُ الاعتقادي: وهو النفاق الأكبر الذي يُظهر صاحبه
الإسلام، ويُبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل
من النار، وقد وصَفَ الله أهله بصفات الشر كلها: من الكفر وعدم الإيمان،
والاستهزاء بالدين وأهله، والسخرية منهم، والميل بالكلية إلى أعداء الدين؛
لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام. وهؤلاء مَوجودون في كل زمان، ولا سيما عندما تظهر
قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته في الظاهر، فإنهم يظهرون الدخول فيه؛ لأجل الكيد
له ولأهله في الباطن؛ ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم؛
فيظهر المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وهو في الباطن
منسلخ من ذلك كله مكذب به، لا يؤمن بالله، ولا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على
بشر جعله رسولًا للناس يهديهم بإذنه، وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه، وقد هتك الله
أستار هؤلاء المنافقين، وكشف أسرارهم في القرآن الكريم، وجلى لعباده أمورهم؛
ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكرَ طوائف العالم الثلاث في أول البقرة:
المؤمنين، والكفار، والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين،
وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم، وشدة فتنتهم على
الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدًّا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته
وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة؛ يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم
وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد.
●
وهذا
النفاق ستة أنواع :
●
1 - تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلم.
●
2 - تكذيبُ بعض ما جاءَ به الرسول - صلى الله عليه وسلم -
●
3 - بُغضُ الرسول - صلى الله عليه وسلم -
●
4 - بغضُ بعض ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم.
●
5 - المسرَّة بانخفاض دين الرسول - صلى الله عليه وسلم.
●
6 - الكراهية لانتصار دين الرسول - صلى الله عليه وسلم.
●
النوع
الثاني: النفاق العملي: وهو عمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان في
القلب، وهذا لا يُخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكونُ فيه إيمان
ونفاق، وإذا كثر صارَ بسببه منافقًا خالصًا، والدليل عليه قوله - صلى الله عليه
وسلم -: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كانَ منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا» «اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر،
وإذا خاصم فجر» .
●
فمن
اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع، فقد اجتمع فيه الشر، وخلصت فيه نعوت المنافقين،
ومَن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال
خير، وخصال شر، وخصال إيمان، وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما
قام به من موجبات ذلك.
●
ومنه:
التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شر،
وخطير جدًّا، وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه، قال ابن أبي مليكة: (أدركت
ثلاثين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهم يخاف النفاق على نفسه)
.
●
الفروق
بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر:
●
1 - إن النفاقَ الأكبرَ يُخرجُ من الملَّة، والنفاقَ الأصغر لا
يُخرجُ من الملَّة.
●
2 - إن النفاق الأكبر: اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق
الأصغر: اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد.
●
3 - إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد
يصدر من المؤمن.
●
4 - إن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف
●
في قبول
توبته عند الحاكم. بخلاف النفاق الأصغر؛ فإن صاحبه قد يتوب إلى الله، فيتوب الله
عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق، ثم
يتوبُ الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق، ويدفعه الله عنه، والمؤمن
يبتلى بوساوس الشيطان، وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة: يا
رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخرّ من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن
يتكلم به، فقال: «ذلك صريح الإيمان» . وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، قال:
«الحمدُ لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة» ، أي حصول هذا الوسواس، مع هذه الكراهة
العظيمة، ودفعه عن القلب، هو من صريح الإيمان) انتهى.
●
وأما أهل
النفاق الأكبر، فقال الله فيهم: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}
[البقرة: 18] . أي: إلى الإسلام في الباطن، وقال تعالى فيهم: {أَوَلَا يَرَوْنَ
أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ} [التوبة: 126] .
●
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية: (وقد اختلف العلماءُ في قبول توبتهم في الظاهر؛ لكون ذلك لا
يُعلم، إذ هم دائمًا يظهرون الإسلام) .
أقوال وأفعال تُنافي التوحيد أو تُنقِصُه
●
ادِّعاء
علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما :
●
المراد
بالغيب: ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية وما لا يرونه، وقد اختص
الله تعالى بعلمه، وقال تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: 65] .
●
فلا يعلم
الغيب إلا الله سبحانه وحده، وقد يُطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة، قال
تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 26، 27] .
●
أي: لا
يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته، فيظهره على ما يشاء من الغيب؛ لأنه
يُستدل على نبوته بالمعجزات التي منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه،
وهذا يعم الرسول الملكي والبشري، ولا يطلع غيرهما لدليل الحصر. فمن ادّعى علم
الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر، سواء
ادّعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان، أو الكهانة أو السحر أو التنجيم، أو غير
ذلك، وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الإخبار عن مكان الأشياء
المفقودة والأشياء الغائبة، وعن أسباب بعض الأمراض، فيقولون: فلان عَمِلَ لكَ كذا
وكذا فمرضتَ بسببه، وإنما هذا لاستخدام الجن والشياطين، ويظهرون للناس أن هذا يحصل
لهم عن طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع والتلبيس. قال شيخُ الإسلام ابن تيمية
(والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه
من السمع، وكانوا يَخلطون الصِّدقَ بالكذب) إلى أن قال: (ومن هؤلاء من يأتيه
الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير
به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما) انتهى.
●
وقد يكون
إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية،
كأوقات هُبوب الرياح ومجيء المطر، وتغير الأسعار، وغير ذلك من الأمور التي يزعمون
أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها.
●
ومن
ادَّعى علم الغيب أو صدَّق من يدَّعيه فهو مشركٌ كافر؛ لأنه يدَّعي مشاركة الله
فيما هو من خصائصه.
السحر
●
- فالسحرُ عبارةٌ عما خفي ولَطُفَ سببُهُ
●
سُمِّي
سِحْرا؛ لأنه يحصل بأمور خفية، لا تدرك بالأبصار، وهو عزائم ورقى، وكلام يتكلم به،
وأدوية وتدخينات، وله حقيقة. ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيُمرض ويقتُل ويفرق
بين المرء وزوجه، وتأثيره بإذن الله الكوني القَدَريّ، وهو عمل شيطاني، وكثير منه
لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بما تحب، والتوصل إلى
استخدامها بالإشراك بها؛ ولهذا قرنهُ الشارع بالشرك، حيث يقول النبي - صلى الله
عليه وسلم -: «اجتنبوا السبعَ الموبقات، قالوا: وما هي؟ قال: الإشراكُ بالله،
والسحر ... » الحديث. فهو داخل في الشرك من ناحيتين:
●
الناحية
الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين، والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه؛
ليقوموا بخدمة الساحر، فالسِّحرُ من تعليم الشياطين، قال تعالى: {وَلَكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102] .
●
الثانية:
ما فيه من دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال، قال تعالى:
{وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ}
[البقرة: 102] ، أي: نصيبٌ.
●
وإذا كان
كذلك فلا شكَّ أنه كفر وشرك يناقض العقيدة، ويجبُ قتل متعاطيه، كما قتله جماعة من
أكابر الصحابة - رضي الله عنهم - وقد تساهل الناس في شأن الساحر والسِّحر، ورُبما
عدوا ذلك فنًّا من الفنون التي يفتخرون بها، ويمنحون أصحابها الجوائز والتشجيع،
ويُقيمون النوادي والحفلات والمسابقات للسحرة، ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين،
أو يسمونه بالسيرك، وهذا من الجهل بالدين والتهاون بشأن العقيدة، وتمكين للعابثين.
●
والكهانةُ
والعِرافة:
●
وهما
ادعاء علم الغيب، ومعرفة الأمور الغائبة، كالأخبار بما سيقع في الأرض، وما سيحصل،
وأين مكان الشيء المفقود؛ وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من
السماء، كما قال تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ
تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ
كَاذِبُونَ} [الشعراء: 221 - 223] .
●
وذلك أن
الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة، فيلقيها في أذن الكاهن، ويكذب الكاهن مع
هذه الكلمة مائة كذبة، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي سُمعت من السماء، والله
عز وجل هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك، بكهانة أو غيرها،
أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكًا فيما هو من خصائصه. والكهانة لا تخلو من
الشرك؛ لأنها تَقَرُّبٌ إلى الشياطين بما يحبون؛ فهي شرك في الربوبية من حيث ادعاء
مشاركة الله في علمه، وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من
العبادة.
●
وعن أبي
هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى كاهنًا فصدقه
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» .
●
ومما يجب
التنبيه عليه والتنبه له: أن السحرة والكهان والعرافين يعبثون بعقائد الناس بحيث
يظهرون بمظهر الأطباء، فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله؛ بأن يذبحوا خروفًا صفته
كذا وكذا، أو دجاجة، أو يكتبون لهم الطلاسم الشركية، والتعاويذ الشيطانية بصفة
حروز يعلقونها في رقابهم، أو يضعونها في صناديقهم، أو في بيوتهم.
●
والبعض
الآخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات، وأماكن الأشياء المفقودة؛ بحيث يأتيه الجهال
فيسألونه عن الأشياء الضائعة، فيخبرهم بها أو يحضرها لهم، بواسطة عملائه من
الشياطين. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات، أو بمظهر الفنان، كدخول
النار ولا تؤثر فيه، وضرب نفسه بالسلاح، أو وضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر
فيه، أو غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان، أو هي أمور
تخيلية لا حقيقة لها؛ بل هي حيل خفية يتعاطونها أمام الأنظار، كعمل سحرة فرعون
بالحبال والعصي.
● تقديم القرابين
والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها:
●
لقد سدّ
النبي - صلى الله عليه وسلم - كل الطرق المفضية إلى الشرك، وحذّر منها غاية التحذير،
ومن ذلك: مسألة القبور، قد وضع الضوابط الواقية من عبادتها، والغلو في أصحابها،
ومن ذلك:
●
1 - أنه قد حذّر - صلى الله عليه وسلم - من الغلو في الأولياء
والصالحين؛ لأن ذلك يؤدِّي إلى عبادتهم، فقال: «إياكم والغُلُوَّ، فإنما أهلك من
كان قبلكم الغُلُوُّ» وقال: «لا تُطروني كما أطرتِ النصارى ابن مريم، إنما أنا
عبدٌ فقولوا عبدُ الله ورسوله» .
●
قال
العلامة ابن القيم - رحمه الله -: (ومن جمع بين سنة رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - في القبور، وما أمر به ونهى عنه، وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر
الناس اليوم رأى أحدُهما مضادًا للآخر مناقضًا له؛ بحيث لا يجتمعان أبدًا؛ فنهى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها، ونهى
عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت
الله، ونهى عن إيقاد السُّرُج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل
عليها، ونهى عن أن تُتَّخذَ عيدًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك، ويجتمعون لها
كاجتماعهم للعيد أو أكثر.
●
وأمر
بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه «عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بنُ أبي
طالب رضي الله عنه: ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوَّيته» . وفي صحيحه أيضًا عن
ثُمامَة بن شُفيّ قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا،
فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر
بتسويتها» . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا
يُعبد»
●
2 - وحذر - صلى الله عليه وسلم - من البناء على القبور، كما روى
أبو الهياج الأسدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما
بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا
مشرفًا إلا سوَّيته» .
●
3 - ونهى عن تجصيصها والبناء عليها، عن جابر رضي الله عنه قال:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى
عليه» «بناء» .
●
4 - وحذَّر - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عند القبور، عن عائشة
رضي الله عنها قالت: «لما نُزِلَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح
خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنةُ الله على اليهود
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذرُ ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير
أنه خشي أن يُتَّخذَ مسجدًا» .
●
وقال -
صلى الله عليه وسلم -: «ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد،
ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» .
●
واتخاذُها
مساجد معناهُ: الصلاة عندها وإن لم يبن مسجد عليها؛ فكلُّ موضع قصد للصلاة فيه فقد
اتُّخذَ مسجدًا، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»
فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد.
●
وقد خالف
أكثر الناس هذه النواهي، وارتكبوا ما حذر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقعوا
بسبب ذلك في الشرك الأكبر؛ فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات، وجعلوها مزارات
تمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر، من الذبح لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم،
وصرف النذور لهم، وغير ذلك.
●
قال
العلامة ابن القيم - رحمه الله -: (ومن جمع بين سنة رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - في القبور، وما أمر به ونهى عنه، وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر
الناس اليوم رأى أحدُهما مضادًا للآخر مناقضًا له؛ بحيث لا يجتمعان أبدًا؛ فنهى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها، ونهى
عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت
الله، ونهى عن إيقاد السُّرُج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل
عليها، ونهى عن أن تُتَّخذَ عيدًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك، ويجتمعون لها
كاجتماعهم للعيد أو أكثر.
●
وأمر
بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه «عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بنُ أبي
طالب رضي الله عنه: ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوَّيته» . وفي صحيحه أيضًا عن
ثُمامَة بن شُفيّ قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا،
فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر
بتسويتها» . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا
يُعبد»
● حكم الاستهزاء بالدين
والاستهانة بحرماته:
●
الاستهزاء
بالدين ردة عن الإسلام، وخروج عن الدين بالكلية، قال الله تعالى: {قُلْ
أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا
قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65، 66] .
●
هذه
الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر، وأن الاستهزاء بالرسول كفر، وأن الاستهزاء
بآيات الله كفر، فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها. والذي حصل من
هؤلاء المنافقين أنهم استهزءوا بالرسول وصحابته؛ فنزلت الآية.
●
فالاستهزاء
بهذه الأمور متلازم، فالذين يستخِفُّون بتوحيد الله تعالى، ويعظمون دعاءَ غيره من
الأموات؛ وإذا أمروا بالتوحيد ونُهوا عن الشرك استخفُّوا بذلك، كما قال تعالى:
{وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ
اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا
عَلَيْهَا} [الفرقان: 41، 42] .
●
فاستهزءوا
بالرسول - صلى الله عليه وسلم - لما نهاهم عن الشرك، وما زال المشركون يعيبون
الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون، إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في
أنفسهم من تعظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم؛ إذا رأى من يدعو إلى التوحيد
استهزأ بذلك؛ لما عنده من الشرك، قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة: 165] .
●
فمن
أحبَّ مخلوقًا مثل ما يُحبّ الله فهو مشرك.
●
والاستهزاء
على نوعين:
●
أحدهما:
الاستهزاء الصريح، كالذي نزلت الآية فيه، وهو قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء،
أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسُنًا، ولا أجبن عند اللقاء. أو نحو ذلك من أقوال
المستهزئين، كقول بعضهم: دينكم هذا دينٌ خامس، وقول الآخر: دينكم أخرق، وقول الآخر
إذا رأى الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر: جاءكم أهل الدِّين، من باب السُّخرية
بهم، وما أشبه ذلك مما لا يُحصى إلا بكلفة؛ مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم
الآية.
●
النوع
الثاني: غير الصريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل: الرمز بالعين، وإخراج
اللسان، ومدّ الشفة، والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله، أو سنة رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - أو عند الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ومثل هذا ما يقوله
بعضهم: إنَّ الإسلام لا يَصلُحُ للقرن العشرين؛ وإنما يصلح للقُرون الوسطى، وأنه
تأخُّرٌ ورجعيةٌ، وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازير، وأنه ظَلَم
المرأة حقوقها؛ حيث أباح الطلاق، وتعدد الزوجات. وقولهم: الحكمُ بالقوانين الوضعية
أحسنُ للناس من الحكم بالإسلام.
●
حكم
الحلف بغير الله :
●
الحلف:
هو اليمين، وهي: توكيد الحكم بذكر مُعَظَّم على وجه الخصوص. والتعظيم: حق لله
تعالى، فلا يجوز الحلف بغيره، فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله،
أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره والحلف بغير الله شرك؛ لما
روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف
بغير الله فقد كفر أو أشرك» وهو شرك أصغر، إلا إذا كان المحلوف به معظَّمًا عند
الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر، كما هو الحال اليومَ عند عُبَّاد
القبور، فإنَّهم يخافون مَنْ يعظمون من أصحاب القبور، أكثر من خوفهم من الله
وتعظيمه، بحيث إذا طُلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا
كان صادقًا، وإذا طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذبًا.
●
فالحلف
تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين؛ فلا يكثر منها، قال
تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم: 10] . وقال تعالى:
{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] .
●
أي: لا
تحلفوا إلا عند الحاجة، وفي حالة الصدق والبر؛ لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان
على الاستخفاف بالله، وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد، وفي الحديث أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثةٌ لا يُكلّمهم الله، ولا يُزكّيهم،
ولهم عذاب أليم» وجاء فيه: «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع
إلا بيمينه» . فقد شدَّد الوعيد على كثرة الحلف، مما يدلّ على تحريمه احترامًا
لاسم الله تعالى، وتعظيمًا له سبحانه.
●
وكذلك
يحرم الحلفُ بالله كاذبًا وهي: اليمين الغَموسُ وقد وصفَ الله المنافقين بأنهم
يحلفون على الكذب وهم يعلمون.
●
فتلخص من
ذلك:
●
1- تحريم الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن ذلك شرك.
●
2- تحريم الحلف بالله كاذبًا متعمّدًا، وهي الغموس.
●
3- تحريم كثرة الحلف بالله - ولو كان صادقًا - إذا لم تدعُ إليه
حاجة؛ لأنَّ هذا استخفاف بالله سبحانه.
●
4- جواز الحلفِ بالله إذا كان صادقًا، وعند الحاجة.
● التوسل بالمخلوق إلى
الله تعالى:
●
التّوسّل: هو التقرب
إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة: القربة، قال الله تعالى: {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35] .
●
أي
القربة إليه سبحانه بطاعته، واتباع مرضاته.
●
والتوسل
قسمان:
●
القسم
الأول: توسل مشروع، وهو أنواع:
●
1 - النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما أمرَ
الله تعالى بذلك في قوله: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ} [الأعراف: 180] .
●
2 - النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال
الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان: {رَبَّنَا إِنَّنَا
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا
مَعَ الْأَبْرَارِ} [آل عمران: 193] .
●
وكما في
حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فسدت عليهم باب الغار، فلم يستطيعوا
الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون.
●
3 - النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بتوحيده، كما توسل يونس
عليه السلام: {فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ} [الأنبياء: 87] .
●
4 - النوع الرابع: التّوسُّلُ إلى الله تعالى بإظهار الضَّعف
والحاجة والافتقار إلى الله، كما قال أيوب عليه السلام: {أَنِّي مَسَّنِيَ
الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأنبياء: 83] .
●
5 - النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، كما
كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو الله لهم،
ولما تُوفي صاروا يطلبون من عمه العباس - رضي الله عنه - فيدعو لهم.
●
6 - النوع السادس: التّوسُّلُ إلى الله بالاعتراف بالذنب: {قَالَ
رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} [القصص: 16] .
●
2 - والتوسل بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بجاه غيره لا
يجوز:
●
والحديث
الذي فيه: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم» حديث مكذوب،
ليس في شيء من كتب المسلمين التي يُعتمد عليها، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث
وما دامَ لا يصح فيه دليل، فهو لا يجوزُ؛ لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح.
●
3 - والتوسل بذوات المخلوقين لا يجوز:
●
لأنه إن
كانت الباء للقسم، فهو إقسام به على الله تعالى، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على
المخلوق لا يجوز، وهو شرك كما في الحديث؛ فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل
وعلا؟ !
●
وإن كانت
الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببًا للإجابة، ولم يشرعه
لعباده.
●
4 - والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين:
●
الأول:
أن الله سبحانه لا يجب عليه حقّ لأحد، وإنَّما هو الذي يتفضّل سبحانه على المخلوق
بذلك، كما قال تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم:
47] .
●
فكون
المطيع يستحق الجزاء، هو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق
المخلوق على المخلوق.
●
الثاني:
أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حقٌّ خاص به، لا علاقة لغيره به، فإذا
توسل به غير مستحقه كان متوسلًا بأمر أجنبي، لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيئًا.
●
وأما
الحديث الذي فيه: «أسألك بحق السائلين» فهو حديث لم يثبت؛ لأن في إسناده عطية
العوفي، وهو ضعيف مجمع على ضعفه، كما
● حكم الاستعانة
والاستغاثة بالمخلوق:
●
الاستعانة:
طلب العون والمؤازرة في الأمر.
●
والاستغاثة:
طلب الغوث، وهو إزالة الشدة.
●
فالاستغاثة
والاستعانة بالمخلوق على نوعين:
●
النوع
الأول: الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز، قال تعالى:
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] .
●
وقال
تعالى في قصة موسى عليه السلام: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى
الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [القصص: 15] .
●
وكما
يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها، مما يقدر عليه المخلوق.
●
النوع
الثاني: الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة
والاستعانة بالأموات، والاستغاثة بالأحياء، والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا
الله من شفاء المرضى، وتفريج الكُرُبات ودفع الضر، فهذا النوع غير جائز، وهو شرك
أكبر، وقد كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - منافق يؤذي المؤمنين، فقالَ
بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا المنافق، فقال
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لا يُستغاثُ بي، وإنما يستغاث بالله» وكره -
صلى الله عليه وسلم - أن يُستعمل هذا اللفظ في حقّه، وإن كان مما يقدر عليه في
حياته؛ حمايةً لجناب التوحيد وسدًّا لذرائع الشرك، وأدبًا وتواضعًا لربه، وتحذيرًا
للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي -
صلى الله عليه وسلم - في حياته، فكيف يُستغاثُ به بعد مماته، ويُطلبُ منه أمور لا
يقدر عليها إلا الله وإذا كان هذا لا يجوز في حقّه - صلى الله عليه وسلم - فغيره
من باب أولى.
●
● الرقى والتمائم
●
أ -
الرقى:
●
جمع
رُقية، وهي: العُوذَةُ التي يُرقى بها صاحبُ الآفة كالحمَّى والصَّرع، وغير ذلك من
الآفات، ويُسمونها العزائم، وهي على نوعين:
●
النوع
الأول: ما كان خاليًا من الشِّرك، بأن يُقرأ على المريض شيء من القرآن، أو
يُعَوَّذ بأسماء الله وصفاته؛ فهذا مُباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد
رَقى وأمر بالرُّقية وأجازها، فعن عوف بن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا:
يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرِضوا عليَّ رُقاكُم، لا بأسَ بالرقى ما لم
تكن شركًا» .
●
قال
السيوطي: وقد أجمعَ العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام
الله، أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، وما يُعرفُ معناه، وأن
يُعتقَدَ أن الرقية لا تؤثر بذاتها؛ بل بتقدير الله تعالى وكيفيتها: أن يُقرأ
وينفثَ على المريض، أو يقرأ في ماءٍ ويُسقاهُ المريض، كما جاء في حديث ثابت بن
قيس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ تُرابًا من بُطحان، فجعله في قدحٍ، ثم
نفثَ عليه بماءٍ وصبَّه» «عليه» .
●
النوع
الثاني: ما لم يخلُ من الشّرك: وهي الرقى التي يُستعانُ فيها بغير الله، من دعاء
غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الجن، أو بأسماء الملائكة
والأنبياء والصالحين؛ فهذا دعاء لغير الله، وهُوَ شركٌ أكبر. أو يكون بغير اللسان
العربي، أو بما لا يُعرف معناه؛ لأنه يُخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يُعلمُ عنه؛
فهذا النوع من الرقية ممنوع.
●
2 - التمائم:
●
وهي جمع
تميمة، وهي: ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العين، وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء،
وهو على نوعين:
●
النوع
الأول من التمائم: ما كان من القرآن؛ بأن يكتب آيات من القرآن، أو من أسماء الله
وصفاته، ويعلقها للاستشفاء بها؛ فهذا النوع قد اختلف فيه العلماءُ في حكم تعليقه
على قولين:
●
القول
الأول: الجوازُ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهرُ ما رُوي عن عائشة،
وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في
المنع من تعليق التمائم على التمائم التي فيها شرك.
●
القول
الثاني: المنع من ذلك، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن
عامر، وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم: أصحابُ ابن مسعود، وأحمد في
رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بما رواهُ ابن مسعود -
رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الرقى
والتمائم والتولة شرك» .
●
والتولة:
شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
●
المصادر والمراجع:
●
عقيدة
التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. صالح
بن فوزان بن عبد الله الفوزان
●
موسوعة
فقه القلوب.محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري.
●
عقيدة
المؤمن ابو بكر الجزائري.
●
شرح
العقيدة الواسطية،محمد بن صالح بن محمد العثيمين تحقيق: سعد فواز الصميل.
●
الثقافة
الإسلامية ، أحمد محمد أحمد الجلى.
●
●